| http://www.marocdroit.com/photo/art/default/5839152-8707065.jpg الدكتور العربي محمد مياد 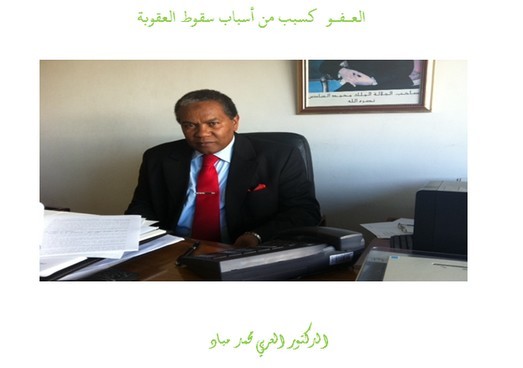 نص الفصل 49 من مجموعة القانون الجنائي المغربي أنه " تنفذ على المحكوم عليه العقوبات الصادرة ضده بتمامها ، إلا إذا طرأ سبب من أسباب الانقضاء أو الإعفاء أو الإيقاف الآتي بيانها: "1 ـ 2 ـ 3 ـ 4 ـ العفو......" كما نص الفصل 53 من نفس القانون على أن " العفو حق من حقوق الملك ، ويباشر وفق الترتيبات التي تضمنها الظهير رقم 1.57.387 الصادر في 16 رجب 1377 موافق 6 يبراير 1958 بخصوص العفو ." إن الدراسة المتمعنة لكل من الفصلين السالفين ، تجعل الدارس ينطلق من مبدأين اثنين وهما : ـ المبدأ الأول وهو ما تضمنه الفصل 49 ومفاده أن القاعدة العامة هي أن العقوبة إنما وجدت إلا من أجل أن تنفذ بالكامل على الجاني . هذا المبدأ مستمد من وظيفة القانون الجنائي المغربي الذي بني على أسس أفكار المدرسة التقليدية باعتبار وظيفة العقوبة الأخلاقية.[1] ـ والثانية، من حق الملك إعفاء المحكوم عليه من العقوبة إما كليا جزئيا، لكن ضمن الترتيبات التي نص عليها قانون صادر سنة 1958 ، أي قبل صدور مجموعة القانون الجنائي الجاري بها العمل بعد الاستقلال. ذلك أن هذه المجموعة صدرت بتاريخ 26 نونبر 1962 وتم نشرها بالجريدة الرسمية بتاريخ 5 يونيو 1963، ودخلت حيز التنفيذ ابتداء من 17 يونيو 1963 . وهوـ أي قانون العفو ـ صدر في ظل القانون الجنائي الصادر بتاريخ 24 أكتوبر 1953 كما وقع تعديله وتتميمه المطبق في منطقة نفوذ الحماية الفرنسية ، وكذا في ظل مقتضيات قانون العقوبات الصادر بتاريخ فاتح يونيو 1914 المطبق بالمنطقة الشمالية سابقا كما وقع تعديله وتتميمه ، وكذا ظهير 15 يناير 1925 الصادر بقانون العقوبات بمنطقة طنجة الدولية سابقا كما وقع تعديله وتتميمه . وهذا ما يدفعنا إلى التساؤل إلى أي حد استطاع قانون العفو تجسيد السياسة الجنائية كما تصورها واضعو مجموعة القانون الجنائي ، ومن باب الأولى نتساءل إلى أي حد يمكن اعتماد نص قانون صادر قبل وجود أول دستور مكتوب للمغرب بعد الاستقلال ؟ ثم إذا كان من حق الملك إصدار العفو ، فهل هذا الحق مطلق أم تحكمه ضوابط وترتيبات قانونية محكمة ؟ ومن الدستور باعتباره يجسد إرادة الأمة[2]؟ للإجابة على هذه الأسئلة وغيرها ، يجدر بنا معرفة المسطرة القانونية للعفو ، ثم آثار العفو ، ثم ما هي الطبيعة القانونية للعفو وذلك من خلال فصلين . الفصل الأول : مفهوم العفو ومسطرته القانونية يكون من المفيد تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين ، نخصص المبحث الأول لتحديد مفهوم العفو والمبحث الثاني لمسطرته القانونية. المبحث الأول : مفهوم العفو كما أسلفنا نظم الظهير الشريف رقم 1.57.387 بتاريخ 6 فبراير 1958 كما وقع تعديله وتتميمه العفو ، وقد تضمن الفصل الثاني منه على أنه " لا يجوز إصدار العفو إلا إذا أصبح الحكم بالعقوبة المطلوب العفو من أجله لا مرد له وقابلا للتنفيذ " وعلى هذا الأساس كان العفو الخاص سببا من أسباب سقوط العقوبة دون أن يكون مؤثرا على سريان الدعوى العمومية . غير أنه بمقتضى التعديل الذي دخل على ظهير العفو بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.77.226 بتاريخ 8 أكتوبر 1977 [3] تغير الأمر بحيث نص الفصل الأول منه على ما يلي : "إن العفو الذي يرجع النظر فيه إلى جنابنا الشريف يمكن إصداره سواء قبل تحريك الدعوى العمومية أو خلال ممارستها أو على إثر حكم بعقوبة أصبح نهائيا ". وهذا يعني أن صلاحيات الملك في منح العفو توسعت بشكل يجعلها تباشر سواء قبل تحريك المتابعة أو خلالها أو بعد صدور حكم نهائي غير قابل للطعن . وبالتالي يكون هذا التعديل قد وضع العفو الخاص الذي يصدره الملك في نفس مرتبة العفو الشامل وأمسى سببا من أسباب سقوط الدعوى العمومية ومحو العقوبة إذا صدرت. ويرى جانب من الفقه [4] أنه من المستبعد استعمال العفو الخاص قبل صدور الحكم النهائي في غير الجرائم السياسية أو لأسباب غير سياسية وهو المجال الذي يستعمل فيه عادة العفو الشامل . غير أنه في نظرنا من أجل فهم الفصل الأول من ظهير العفو المعدل يجب وضع التعديل في إطاره التاريخي الذي سن فيه ، خاصة وأن هذه المبادرة تمت بعد تنازل الدولة على بعض اختصاصاتها إلى الجماعات الترابية في إطار الميثاق الجماعي ، وتم تفويض بعض صلاحيات رجال السلطة من باشاوات وقواد إلى السلطة المنتخبة ولا سيما ما تعلق بالشرطة الإدارية ،وما استتبع ذلك من زلزال على مستوى نفسية بعض رحال السلطة وإحساسهم بتقوية نفوذ رؤساء المجالس الجماعية على حساب الاختصاصات التقليدية لرجال السلطة ،مما تطلب تقوية سلطات عمال العمالات والأقاليم سواء من حيث الضبط أو الحفاظ على الأمن ، أو التنمية الاقتصادية والاجتماعية أو الإشراف على أجهزة الدولة على الصعيد المحلي ، باستثناء القضاء والأحباس ، وهذا ما تضمنه الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 163. 75. 1 بتاريخ 15 فبراير 1977 يتعلق باختصاصات العامل ، وكذا المناخ السياسي الناجم عن استرجاع المغرب لصحرائه الجنوبية . وهذا ما يجعل مقتضيات الفصل الأول من قانون العفو منافية للسياسة الجنائية المغربية المبنية كما قلنا على العقاب، وبدرجة ثانية على الإصلاح ، خاصة وأن الفصل 49 من مجموعة القانون الجنائي أكد على أن العفو يشمل العقوبة وليس المتابعة ، وبمعنى أدق أن العفو وجد لكي يعفي الجاني من العقوبة الصادرة في حقه سواء كانت هذه العقوبة أصلية أو إضافية . وتكون العقوبة أصلية عندما يسوغ الحكم بها وحدها دون أن تضاف إلى عقوبة أخرى كعقوبة الإعدام والعقوبة السجنية أو الحبسية أو الغرامة ...، بينما تكون العقوبة إضافية عندما لا يسوغ الحكم بها وحدها ، أو عندما تكون ناتجة عن الحكم بعقوبة أصلية [5]. ويدخل في حكمها المصادرة ، العزل من الوظيفة العمومية ... وهذا يعني أنه لا يمكن تصور صدور العفو قبل أن يرفع القضاء يده عن النازلة ، أما في الحالة التي يكون العفو سابقا على صدور الحكم النهائي ، فإن ذلك ما يدخل في مجال تسيير الدعوى العمومية ، لأن الدعوى التي تمارس أمام القضاء الزجري ضد مقترف الفعل ألجرمي من أجل المطالبة بمعاقبته تثار باسم المجتمع بأكمله[6] سواء من طرف قضاة النيابة العامة أو من طرف الموظفين المكلفين بذلك قانونا [7]. والنتيجة أن السلطة القضائية في شخص النيابة العامة هي المؤهلة قانونا بإقامة وممارسة الدعوى العمومية وكذا مراقبتها . كل ذلك تحت أعين وزير العدل والحريات باعتباره المشرف قانونا على تنفيذ السياسة الجنائية .[8]، و يمكن للنيابة عدم تحريك المتابعة إذا ما تبين لها أن الشكاية كيدية أو تنقصها أدلة الاتهام الدامغة، وهذا يعني ان المشرع المغربي لم يأخذ بالأسلوب الاتهامي بحذافيره ، وإنما زاوج بين هذا الأسلوب والأسلوب التقديري، بحيث ترك للنيابة العامة فسحة من أجل تحريك المتابعة من عدمها . أما في حالة تحريك المتابعة ، فإنها تبقى سارية ما لم توجد أسباب لسقوطها . هذه الأسباب الواردة على سبيل الحصر في المادة 4 من قانون المسطرة الجنائية التي نصت بالحرف " تسقط الدعوى العمومية بموت الشخص المتابع ، وبالتقادم ، وبالعفو الشامل ، وبنسخ المقتضيات الجنائية التي تجرم الفعل وبصدور مقرر اكتسب قوة الشيء المقضي به . وتسقط بالصلح عندما ينص القانون صراحة على ذلك . تسقط أيضا بتنازل المشتكي عن شكايته ، إذا كانت الشكاية شرطا ضروريا للمتابعة ، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ." والعفو الشامل يصدر عن السلطة التشريعية في شكل نص تشريعي صريح ، يحدد ما يترتب عليه من آثار دون المساس بحقوق الغير .[9] ولا علاقة له بالعفو الخاص الذي يصدر عن الملك. ونظرا لأن النص الأصلي للعفو صدر قبل صدور المسطرة الجنائية [10]فإن المعول عليه من حيث المسطرة هو هذا القانون الأخير.وهذا ما يعبر عنه بالإلغاء الجزئي الضمني ، ولا يجوز التمسك في هذه الحالة بأن النص الخاص يقدم على العام ، خاصة وأن المادة 756 من المسطرة الجنائية عندما نسخت بعض النصوص القانونية إنما ورد نسخها على سبيل المثال وليس الحصر . ويؤيد ما ذهبنا إليه أن القضاء المقارن ولا سيما الفرنسي قضى بأن العفو المنصوص عليه في الفصل 10 من قانون 4 غشت 1981 لا يمكن منحه أو طلبه إلا بعد صدور حكم نهائي في الموضوع .[11] غير أن المجلس الأعلى (محكمة النقض) قضى في أحد قراراته[12] أن تمتيع العارض بالعفو المولوي بمناسبة ذكرى 20 غشت 1984 جعل حدا لممارسة الدعوى العمومية في حقه مما تبقى معه جميع دفوعه الواردة على الدعوى العمومية عديمة الجدوى . وهنا تمسكت محكمة القانون بحرفية النص، بحيث منعت المستفيد من العفو، من قبول طعنه بالنقض، حتى لو كانت له دفوعاته متينة حول القرار الإستئنافي الذي أدانه ، وكان من شأن ذلك أن يدفع المحكمة إلى نقض هذا القرار . والحكمة تقتضي أن العفو قبل صدور الحكم لا يمكن تكييفه بالعفو بالمفهوم الصرف للمصطلح ، وإنما هي إعفاء من المتابعة ، والإعفاء قد يصادف أن تكون المتابعة غير متينة أو أن الفعل ألجرمي طاله التقادم ومن المؤكد أن المحكمة ستقضي بسقوط المتابعة . المبحث الثاني: المسطرة القانونية للعفو ميز الفصل 8 من ظهير العفو بين نوعين من العفو ، فهناك الصنف الأول وهو العفو الفردي ، ويتم تلقائيا من الملك ، أو بناء على طلب . وفي هذه الحالة الأخيرة، يكون الطلب إما من المحكوم عليه شخصيا ،أو من أقاربه أو أصدقائه ، ومن النيابة العامة أو المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج . وقد أضافت الفقرة السابعة من المادة 596 المسطرة الجنائية إمكانية تقديم مقترحات حول العفو من طرف قاضي تطبيق العقوبات .[13] أما الصنف الثاني من العفو ، فهو العفو الجماعي ، ويصدر بمناسبة الأعياد الوطنية أو الدينية . وقد عهدت المادة 1 من المرسوم رقم 2.08.772 بتاريخ 21 مايو 2009 بتحديد اختصاصات وتنظيم المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بهذه المندوبية صلاحيات تهيئ الملفات المتعلقة بطلبات واقتراحات العفو بتنسيق مع القطاعات الحكومية المعنية بالأمر . وتقوم بدراسة طلبات العفو بناء على طلب، لجنة يكون مقرها بالرباط ، وتتكون من الأشخاص الآتي ذكرهم : ـ وزير العدل والحريات أو من ينوب عنه بصفته رئيسا ؛ ـ المدير العام للديوان الملكي أو من ينوب عنه؛ ـ الرئيس الأول لمحكمة النقض أو من ينوب عنه ؛ ـ الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض أو من ينوب عنه ؛ ـ مدير الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل والحريات أو من ينوب عنه ؛ ـ المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج أو من يمثله ؛ ـ ضابط من الأركان العامة للقوات المسلحة الملكية يعينه الوزير المكلف بإدارة الدفاع الوطني ، إذا كان الأمر يتعلق بعقوبات أصدرتها المحكمة العسكرية . ويتولى مهمة المقرر موظف تابع لوزارة العدل والحريات. وهكذا نلاحظ هيمنة السلطة التنفيذية على هذه اللجنة ، وذلك من خلال كل من وزير العدل والحريات، و مدير الشؤون الجنائية والعفو، والمدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج ، يضاف إليهم ، المدير العام للديوان الملكي ، وبشكل أو بآخر الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض . ومن الناحية العضوية فإن السلطة القضائية لم تمثل إلا من طرف الرئيس الأول لمحكمة النقض، اعتبارا لاستقلال هذه المؤسسة عن تعليمات وزير العدل والحريات أو مديرية الشؤون الجنائية والعفو أو غيرها. كما يلاحظ غياب بعض المؤسسات الاستشارية للملك من قبيل المجلس الوطني لحقوق الإنسان ووسيط المملكة ، وكذا المجلس الأعلى العلمي . وحتى وطبيب نفساني أو عالم الاجتماع .... وتجتمع لجنة العفو بناء على دعوة من رئيسها وزير العدل والحريات في التواريخ التي يحددها ، ولاسيما عند اقتراب إحدى المناسبات الدينية أو الوطنية [14]. وقد عهد الفصل 12 من ظهير العفو إلى هذه اللجنة بدراسة الطلبات المقدمة في هذا الصدد ، ولها أن تطلب جميع المعلومات المتعلقة بكل طلب على حدة ، كما تبدي رأيها في العفو ، وترفع تقريرها إلى الديوان الملكي من أجل البت في الطلب بما يقتضيه نظر جلالة الملك . والتساؤل المطروح ، ما هي الجهة التي تستقي منها اللجنة المذكورة معلوماتها ؟ لاشك أن وجود النيابة العامة في شخص الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض و المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج كعضوين في اللجنة من شأنه أن يفيد في الحصول على المعلومات الضرورية والمفيدة ، سواء تعلق الأمر بوجود متابعات أخرى غير تلك موضوع الحكم النهائي ، أو من حيث خطورة الأفعال المنسوبة لطالب العفو ، أو خطورة المجرم نفسه، أو من حيث حسن السيرة والسلوك داخل المؤسسة السجنية . الفصل الثاني : الطبيعة القانونية للعفو وآثاره نص الفصل 58 من الدستور على أنه يمارس الملك حق العفو . لكن التساؤل المطروح هو كيف يمارس الملك هذا الاختصاص الدستوري ؟ هل عن طريق ظهير شريف أم مجرد موافقة كتابية على اللائحة المرفوعة له من طرف لجنة العفو إذا تعلق الأمر بطلب أو تلك المعدة من طرف الديوان الملكي إذا كان العفو فرديا ؟ ثم ما هي طبيعة هذا القرار ، هل يعتبر قرارا إداريا قابلا للطعن أمام القضاء الإداري ، وإذا كان كذلك ، فما هي الجهة المختصة للنظر في الطعن ؟ طبقا للفصل 13 من ظهير العفو ، يعهد إلى وزير العدل والحريات بتنفيذ الأمر الملكي المتعلق بالعفو . لكن هل يأخذ هذا الأمر الملكي شكل ظهير شريف يوقع بالعطف من طرف رئيس الحكومة ، أم مجرد قرار عادي يأخذ شكل موافقة على اللائحة ؟ استنادا إلى الفصل 42 من الدستور يعتبر الملك رئيس دولة ، يمارس مهامه الدستورية بمقتضى ظهائر ، وتوقع هذه الظهائر بالعطف من قبل رئيس الحكومة باستثناء تلك المنصوص عليها في الفصول 41 و 44 ( الفقرة الثانية ) و47 (الفقرتان 1 و 6) و51 و57 و59 و 130( الفقرتان 1 و 4) و174. وما دام أن الفصل 58 من الدستور هو الذي ينظم العفو ، فإن الظهير الشريف الذي يمارس بمقتضاه الملك حق العفو غير وارد في الاستثناء، وبالتالي يكون وجوبا موقعا بالعطف من طرف رئيس الحكومة . والظهير في هذا الشأن يعتبر قرارا إداريا صادرا عن الملك بصفته جزء من السلطة التنفيذية إلى جانب الحكومة ، ذلك أن العفو كما قلنا يرمي إلى وضع حد للعقوبة وليس إلى محو الجريمة من أساسها. وعلى هذا الأساس يكون قابلا للطعن أمام المرجع الإداري المختص ، أي الغرفة الإدارية بمحكمة النقض . وهذا ما أكده الدستور الحالي في الفصل 118 عندما نص في الفقرة الثانية بأن " كل قرار اتخذ في المجال الإداري ، سواء كان تنظيميا أو فرديا يمكن الطعن فيه بالإلغاء أمام الهيئة القضائية الإدارية المختصة ." ودعوى الإلغاء، كما هو معلوم ، توجه ضد القرارات القابلة للتنفيذ. وفي هذا تجاوز لما استقر عليه المجلس الأعلى عندما قضى بأن " طلب الإلغاء موجه في حقيقته ضد المرسوم الملكي ، وأن الفصل الأول من ظهير 27 شتنبر 1957 يحدد في فقرته الثانية اختصاص المجلس الأعلى وطلبات إلغاء المقررات الصادرة عن السلطات الإدارية بدعوى الشطط في استعمال السلطة وأن المقرر المطعون فيه (المتعلق بإعفاء رجل سلطة ) غير صادر عن سلطة إدارية .[15] وقد يقول قائل بأن قرار العفو من قرارات السيادة ، وبالتالي فهو لا يقبل الطعن . لكن، قبل الجواب يكون من المفيد التساؤل عن المقصود بأعمال السيادة ؟ إن قرارات السيادة من إبتكار السلطة القضائية في الدول العريقة في الديمقراطية كفرنسا مثلا ، ومنها تسرب إلى العمل القضائي المصري. وأمام غياب اجتهاد قضائي مغربي مشهور في الموضوع ، يمكن الاستعانة بالقضاء المصري في الموضوع ، ذلك أن محكمة القضاء المصري اعتبرت في قرار لها صادر بتاريخ 26 يونيو 1951 أن أعمال السيادة هي تلك الأعمال التي تصدر من الحكومة باعتبارها سلطة حكم لا سلطة إدارة ويدخل في حكمها إعلان الأحكام العرفية أو إعلان الحرب ، والضابط فيها معيار موضوعي ، يرجع إلى طبيعة الأعمال في ذاتها لا إلى ما يحيط بها من ملابسات عارضة .[16] يستشف من هذا القرار أن القرارات العادية التي تتخذ تنفيذا للقوانين والمراسيم التطبيقية لا تعتبر من أعمال السيادة ، وهكذا هو حال قرار العفو الذي أخضعه المشرع إلى مسطرة خاصة سواء من حيث إعداد لائحة المستفيدين أو من حيث الجهة المختصة بإعدادها أو الجهة المختصة بتنفيذ العفو . وما دام أن قرار العفو يدخل في إطار القرارات الإدارية التي يتخذها الملك باعتباره رئيس الدولة يمارس السلطة التنظيمية le pouvoir réglementaire . وهذا ما يخوله إمكانية سحب قرار العفو متى تبين له أنه مبني على معطيات غير صحيحة . ويكون السحب بإعدام القرار من أصله وذلك بوضع حد لآثاره في الماضي والمستقبل .[17] شريطة أن يتم ذلك، طالما لم يتحصن القرار بمرور الزمن ، أي داخل الأجل الذي يمكن فيه ممارسة الطعن القضائي .[18] وقد قضى المجلس الأعلى (محكمة النقض) بأن صيانة الحقوق المكتسبة مـن المبادئ العامة التي لا تسمح للسلطات الإدارية بالتراجع في مقررات اتخذتها في نطاق القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل وقت صدورها وخولت المستفيد منها وضعية إدارية معينة إلا في حالة خاصة حسب الظروف والملابسات ، وأنه إذا كان سحب المقرر الإداري ناشئا عن عدم المشروعية المستوجبة للإلغاء من أجل الشطط في استعمال السلطة، فيجب أن يصدر ذلك السحب داخل أجل الطعن بالإلغاء أمام المجلس الأعلى ، ما عدا في حالة استعمال المعني بالأمر مناورات تدليسية للحصول على المقرر الإداري .[19] وصفوة القول فإن مجرد طلب العفو عن المحكوم عليه المعتقل، يخول وزير العدل والحريات إمكانية الأمر بالإفراج عنه ريثما يبث في الطلب إذا كانت المتابعة تتعلق بجنحة أو مخالفة . وهذا أمر ليس بهين على اعتبار أنه يتجاوز اختصاص السلطة القضائية التي قضت بحبسه ، كما أن من شأنه أن يخلق عدم الاستقرار النفسي والاجتماعي ، في الحالة التي لا تتم الاستجابة لطلب العفو ، فهل من حق وزير العدل والحريات آنذاك إصدار أمر باعتقاله سواء مباشرة أو عن طريق النيابة العامة ؟ لكن التساؤل المطروح وبالإلحاح ما هي الآثار المباشرة للعفو ؟ طبقا للفصل الثاني من ظهير العفو فإن من أهم هذه الآثار إما استبدال العقوبة ، مثلا من مؤبد إلى محدد ، أو السجنية إلى الحبسية ، أو الإعفاء من تنفيذها كما لو كانت نافذة فتصبح موقوفة إما كليا أو جزئيا ، أو الإلغاء الكلي أو الجزئي لآثار الحكم بالعقوبة بما في ذلك قيود الأهلية وسقوط الحق الناتج عنه .... غير أن هذا كله ، يجب ألا يؤثر على الجانب المتعلق بالدعوى المدنية ، ذلك أن هذه الأخيرة وإن كانت دعوى تابعة للدعوى العمومية فإنها تحتفظ ببعض الاستقلالية عنها في بعض الأحكام ومن ضمنها إمكانية الطعن في إحداهما دون الأخرى ، وكذا في أسباب الانقضاء. وعلى هذا الأساس فإنه لا يوجد من بين أسباب انقضاء الدعوى المدنية العفو ، عكس الدعوى العمومية ، إذا تمسكنا بحرفية النص ، وهذا ما أكـد عليه الفصل 7 من ظهير العفو الذي نص على أنه " لا يلحق العفو في أي حال من الأحوال ضررا بحقوق الغير." وصفوة القول فإن هناك إرادة ملكية صريحة في تعديل مقتضيات قانون العفو ، وفي اعتقادنا فإن التعديل يجب أن ينصب على جوهر القانون وشكله . + فمن حيث الشكل : ـ يجب توسيع لائحة أعضاء لجنة العفو، بإدخال ممثلي كل من المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ووسيط المملكة ، والمجلس العلمي الأعلى ، والمجتمع المدني ، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية. وطبيب نفساني أو عالم الاجتماع. ـ نشر لائحة المستفيدين من العفو بالجريدة الرسمية،حتى يتمكن كل متضرر من العفو من الطعن داخل الأجل القانوني للطعون الإدارية . + فمن حيث الجوهر: ـ اعتبار العفو مسقطا للعقوبة دون الدعوى العمومية ، ـ تحديد الأفعال الجرمية التي لا تكون قابلة للعفو من قبيل جرائم نهب المال العام ، والجنايات والجنح ضد أمن الدولة الداخلي والخارجي و تلك الماسة بشرف الطفولة والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة ولاسيما المتخلفين عقليا ، وازدراء الأديان السماوية، وغيرها من الجرائم التي تؤدي لا محالة إلى زعزعة استقرار أمن البلاد والعباد والمصالح العليا للوطن . والأمل معقود على هذه الحكومة وكذا البرلمان في إعداد مشروع أو مقترح قانون يستجيب لتطلعات جلالة الملك والشعب المغربي ، وذلك بالسمو بالعفو حتى يكون أحد ركائز الإصلاح والتهذيب وليس مطية للإفلات من العقاب . الهوامش [1] راجع أستاذنا سامي النصراوي ، النظرية العامة للقانون الجنائي ج 1 ط 2 سنة 1991 مطبعة النجاح الجديدة الرباط ص 41 [2] نص الفصل 2 من الدستور بأن السيادة للأمة .... [3] منشور بالجريدة الرسمية عدد 3388مكرر بتاريخ 10 أكتوبر 1977 ص 2849 [4] راجع أستاذنا أحمد الخمليشي : شرح قانون المسطرة الجنائية ، ج 1 ، (الدعوى العمومية ـ الدعوى المدنية ـ البحث التمهيدي ) ط 1 سنة 1980 توزيع مكتبة المعارف ص 89 [5] راجع الفصل 14 من مجموعة القانون الجنائي وما يليه [6] راجع شرح قانون المسطرة الجنائية الجزء الأول منشورات جمعية نشر المعلومة القانونية والقضائية سلسلة الشروح والدلائل ، عدد 2 سنة 2004 ط 2 ص 23 [7] راجع الفصل 3 من المسطرة الجنائية [8] المادة 51 من المسطرة الجنائية [9] الفصل 51 من مجموعة القانون الجنائي [10] صدر الظهير الشريف رقم 1.02.255 بتاريخ 3أكتوبر 2002 بتنفيذ القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية ،ونشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 30يناير 2003 ص 315 [11] Crim 15 novembre 1982 : Bull 256 , voir aussi code De Procédure Pénale, 1988 , Litec Code Paris p 12 [12] قرار عدد 3268/86 بتاريخ 22أبريل 1986 ملف جنائي عدد 13238 منشور بقرارات المجلس الأعلى منشورات المجلس الأعلى في ذكراه الأربعين سنة 1997 ص 77 [13] يعين هذا القاضي بقرار لوزير العدل والحريات لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد [14] يقصد بالمناسبات الدينية والوطنية عيد الفطر وعيد الأضحى وعيد المولد النبوي ، وعيد العرش وعيد الاستقلال وعيد الشباب وذكرى 11 يناير وثورة الملك والشعب . [15] راجع القرار رقم 73 بتاريخ 16 فبراير 1973، اجتهادات الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى في ميدان الوظيفة العمومية ، منشورات وزارة الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري طبعة 1998 ص 19 وما يليها [16] راجع السنة الخامسة ص 1098 ،أشار إليه سليمان محمد الطماوي : القضاء الإداري ن الكتاب الأول قضاء الإلغاء طبعة 1986 دار الفكر العربي ص 392 [17] راجع أستاذنا محمد مرغني : المبادئ العامة للقانون الإداري دراسة مقارنة ط 1980مطبعة الساحل الرباط ص 338 وما يليها [18] راجع المرجع أعلاه الصفحة 339 [19] القرار رقم 63 بتاريخ 2مارس 1979 في الملف الإداري عدد 60862 ، اجتهادات الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى في ميدان الوظيفة العمومية المرجع السابق ص 36 وما يليها المصدرhttp://www.marocdroit.com/الملف-الشهري-العـفـو-كسبب-من-أسباب-سقوط-العقوبة-بقلم-الدكتور_a3922.html | |||
| | |||
| | |||
|
صفحة الفيسبوك
المشاركات الشائعة
-
جامعة ابن زهر كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكـاديـر رسالة لنيل دبلوم نهاية الماستر المتخصص المقاولة والقانون ...
-
تحميل كتاب المسؤولية المدنية د.عبد القادر العرعاري رابط التحميل http://ift.tt/1kZyxNF
-
حمزة الأندلسي بن ابراهيم باحث في القانون الدستوري، علم السياسة كلية الحقوق أكدال مـقـدم...




0التعليقات :