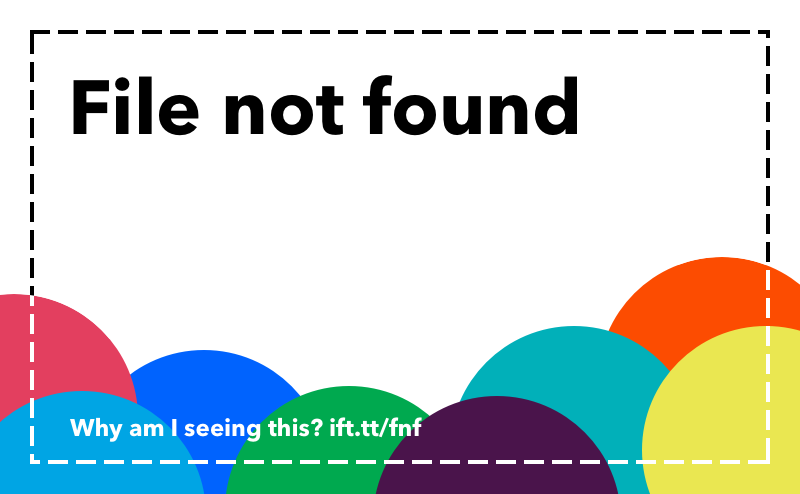
ينبع جوهر دولة الحق و القانون من خضوع سلطات الدولة للقانون بمعناه العام شأنها شأن بقية الأفراد و هو ما يعرف بمبدأ المشروعية، و هو المبدأ التي يجب أن تخضع له الإدارة في كافة تصرفاتها لتتصف جميع أعمالها بالقانونية، و تعد القرارات الإدارية من أبرز الأشكال التي تترجم من خلالها الإدارة إرادتها المنفردة بهدف إحداث أثر قانوني أول إلغائه أو تعديله بغرض ممارسة أنشطتها التي تستهدف تحقيق المصلحة العامة، و ذالك داخل النطاق المحجوز للسلطة التنفيذية دون تجاوز لاختصاصات السلطة التشريعية أو السلطة القضائية احتراما لمبدأ الفصل بين السلطات، و قد أدى تطور الأوضاع الاجتماعية و الاقتصادية و تزايد تدخل الإدارة في الحياة العامة إلى إدخال نوع من المرونة على مبدأ الفصل بين السلطات، بحيث لم يعد مجال التشريع مجالا محجوزا و خاصا للسلطة التشريعية بل أصبحت السلطة التنفيذية تتدخل في مجال التشريع تحت مجموعة من الأسباب و الذرائع عن طريق مقررات تنظيمية تتمتع ببعض خصائص القواعد القانونية كالعمومية و التجريد.
و إذا كانت القوانين تخضع عادة لرقابة قبلية من قبل المؤسسة التشريعية و رقابة بعدية عن طريق القضاء الدستوري للتأكد من مطابقة هذه النصوص للدستور فإن المقررات التنظيمية الصادرة عن السلطة التنفيذية لا تخضع لهذا النوع من الرقابة، كما أن تمتعها بخصائص العمومية و التجريد يجعلها تسمو عن كونها مجرد قرارات إدارية لتقترب من مرتبة النصوص القانونية التي تفلت من رقابة مبدأ المشروعية كمبدأ عام، مما يشكل مسا بحقوق الأفراد و حرياتهم نظرا للنطاق الواسع الذي يمكن أن تشغله المقررات التنظيمية مقارنة بالقرارات الفردية و نظرا للجوانب التي يمكن أن تمسها و التي قد تتصل بشكل مباشر بحقوق الأفراد و حرياتهم.
و قد أثار موضوع خضوع المقررات التنظيمية {اللوائح أو المراسيم} لمبدأ المشروعية نقاشا مستفيضا داخل الأوساط الفقهية القانونية في فرنسا و قد عمل مجلس الدولة الفرنسي على ترجمة هذه النقاشات عن طريق اجتهادات قضائية خلاقة حاولت الدفاع عن مبدأ المشروعية.
و بالنسبة للمشرع المغربي فقد تم التنصيص على خضوع المقررات التنظيمية لرقابة القضاء لأول مرة داخل الوثيقة الدستورية 2011 من خلال الفصل 118 الذي جاء في فقرته الثانية " كل قرار اتخذ في المجال الإداري، سواء كان تنظيميا أو فرديا، يمكن الطعن فيه أمام الهيئة القضائية الإدارية المختصة " مكرسا بذلك رقابة القضاء الإداري على المقررات التنظيمية من خلال أسمى النصوص القانونية،و مما يجب التنبيه إليه أن المقررات التنظيمية هي عبارة عن قرارات تصدر عن السلطة التنفيذية تتسم بخصائص العمومية و التجريد فهي قرارات تسري على جميع الأفراد اللذين تنطبق عليهم شروط معينة و هي إحدى الاستثناءات المطبقة على مبدأ الفصل بين السلطات بموجبه تعمل السلطة التنفيذية على أخذ نطاق يكون عادة من اختصاص السلطة التشريعية و هو ما يجعل هذه المقررات التنظيمية و التي تسمى باللوائح أو المراسيم تعتبر إحدى المصادر المهمة لمبدأ المشروعية، بالإضافة للدستور و القانون فكيف يمكن إعمال رقابة مبدأ المشروعية على هذه المقررات ؟
المبحث الأول: الطبيعة القانونية للمقررات التنظيمية.
تعرف القرارات الإدارية بشكل عام بكونها إفصاح الإدارة عن إرادتها المنفردة الملزمة بمقتضى ما لها من سلطة عامة تقررها القوانين و المراسيم و ذلك بقصد إنشاء أو تعديل أو إلغاء أحد المراكز القانونية متى كان ذلك ممكنا عملا و جائزا قانونا و كان الهدف منه تحقيق مصلحة عامة[1].
و إذا كانت القرارات الإدارية التنظيمية بشكل عام تشترك في الخصائص المشار إليها في هذا التعريف مع القرارات الإدارية الفردية من حيث كونها تعبيرا عن إرادة الإدارة الذاتية الملزمة فإن أثر و مدى هذه القرارات يختلف عن القرارات الفردية من حيث نطاق و حجم التأثير الذي يمكن أن تدخله على المراكز القانونية المعنية بهذه القرارات، حيث أن هذه القرارات تنفرد بخصوصيات معينة تتمثل في خاصيات العمومية و التجريد مما يجعلها مقتربة بذلك من القواعد القانونية أكثر من اقترابها من القرارات الإدارية، بحيث يمكن للقرارات الفردية أن تستمد سلطتها من المقررات التنظيمية { المراسيم } كما يتضح في التعريف أعلاه.
المطلب الأول: تمييز القرار التنظيمي عن القرار الفردي.
تتميز القرارات الإدارية الفردية بكونها تلك القرارات التي تصدر في حق فرد بذاته و محدد باسمه أو في حق مجموعة من الأفراد معينين بذاتهم و محددين بأسمائهم داخل القرار الإداري، و كمثال على ذلك قرارات التعيين في الوظيفة العمومية التي تصدر بالنسبة لشخص أو مجموعة من الأشخاص[2] و تستنفذ هذه القرارات موضوعها بمجرد تطبيقها مرة واحدة.
و تعرف القرارات التنظيمية باشتمالها على قاعدتي العمومية و التجريد، فهي قرارات تسري على جميع الأفراد اللذين تنطبق عليهم شروط معينة ، و قاعدة العمومية التي يتميز بها القرار التنظيمي لا تعني أنه يطبق على كافة الأفراد في المجتمع ولكن الأمر يتعلق بفئة معينة معينين بصفات و خصائص معينة و ليس معينين بذاتهم، فالقرارات التنظيمية تعتبر تشريعا فرعيا يقوم إلى جانب التشريع العادي غير أن هذا التشريع لا يكون مصدره السلطة التشريعية بل السلطة التنفيذية كما أن القرار التنظيمي لا يستنفذ مفعوله بمجرد تطبيقه مرة واحدة و إنما يبقى قائما ليتم تطبيقه مستقبلا.
ولم يضع المشرع المغربي تعريفا محددا للمقررات التنظيمية بل نص فقط بعد تحديده لمجال القانون من خلال الفصل 72 من الدستور على أن المواد التي لا تندرج ضمن مجال القانون تدخل ضمن مجال التنظيم و قد نص الدستور المغربي بشكل صريح على مجموعة من الاختصاصات التي تمارس بموجب مراسيم بشكل مستقل بينما يبقى المجال التنظيمي الأصيل هو المجال التطبيقي الذي بموجبه تقوم المراسيم بتنزيل القوانين و تنفيذها و بذلك يمكن حصر مجالين أساسيين لمجال المقررات التنظيمية.
أ- المقررات التنظيمية التطبيقية:
و يعتبر الفقهاء أن دور المقرر التنظيمي التطبيقي هو دور ثانوي، فهذا الدور لا ينبثق من الدستور مباشرة بل يصدر بناء على وساطة القانون لإتمام هذا الأخير و تكميله، أي إضافة تفاصيل دقيقة لتسهيل عملية تنفيذ القانون،حيث أن هذه المقررات لا يمكنها بأي شكل من الأشكال أن تضيف شيئا جديدا أي وضع قواعد عامة جديدة، بل يقتصر الأمر على وضع إجراءات و تدابير تفصيلية و تكميلية للقانون[3].
فدور المقرر التنظيمي هنا هو وضع الوسائل اللازمة لتنفيذ المقتضيات التشريعية،حيث أن النصوص القانونية التي يضعها البرلمان تقتصر عادة على وضع الأحكام العامة و الخطوط العريضة دون الدخول في التفاصيل و الجزئيات التي تكون عرضة للتغيير المستمر، حيث يستحيل على المشرع العادي الإلمام بكل التفاصيل و التدابير التنظيمية المعقدة.
و يمكن القول أن المقررات التنظيمية من خلال دورها التطبيقي تساهم في تخفيف العبء عن السلطة التشريعية التي عليها أن تتفرغ لوضع المبادئ و الوسائل الرئيسية تاركة ما عداها للسلطة التنفيذية التي تتولى تنظيمها و هذا الدور الأساسي و إن كانت تقوم به السلطة التنفيذية في شكل قرارات إدارية ملزمة فإن هذه القرارات لا تخلو من خاصيتي العمومية و التجريد للتمكن من تطبيق القواعد القانونية المرتبطة بهذه المقررات على نطاق واسع، حيث تعمل المقررات التنظيمية على استعارة هاتين الخاصيتين من القانون للتمكن من تنزيل الإجراءات و التدابير التفصيلية و تطبيقها على كل من تنطبق عليه القاعدة القانونية المستمدة من النص القانوني الأصلي ذاته فبدون خاصيتي العمومية و التجريد تفقد القرارات التنظيمية خصوصياتها و تتساوى بذلك مع القرارات الإدارية الفردية.
و التزاما بهذا الدور الذي تقوم به المقررات التنظيمية بالنسبة لتطبيق النصوص القانونية فإن المقرر التنظيمي لا يمكنه التدخل إلى تبعا و تنفيذا للقانون بحيث تبقى مهمة تنفيذ القوانين مهمة تبعية أي تابعة للقانون المراد تنفيذه، فإذا كانت الإدارة تستمد سلطتها في ممارسة السلطة التنظيمية التطبيقية من نص الدستور فإن حقها هذا يتوقف على القانون الذي يلعب دور الوسيط بين النص الدستوري و المقرر التنظيمي[4].
ب- المقررات التنظيمية المستقلة.
حدد الفصل 71 من دستور 2011 مجالات القانون و هي 30 مجالا و جاء في الفصل 72 من الدستور " يختص المجال التنظيمي بالمواد التي لا يشملها اختصاص القانون" ولم يعمل المشرع على وضع تعريف للمجال التنظيمي بل اكتفى بحصر مجال القانون المحددة في الفصل 71 في 30 مجالا ليبقى ما دون ذلك من المجالات التي لا تدخل في اختصاص القانون من اختصاصات مجال التنظيم و دون وضع تمييز بين مجال التنظيم التطبيقي و مجال التنظيم المستقل.
كما أنه بالرجوع للمادة 9 من القانون 41-90 المحدث بموجبه محاكم إدارية نجدها تنص على اختصاص المجلس الأعلى محكمة النقض حاليا بالبث في المقررات التنظيمية و الفردية الصادرة عن الوزير الأول و ذلك دون تمييز بين المقرر التنظيمي التطبيقي و المقرر التنظيمي المستقل، لذلك فإن نعت السلطة التنظيمية غير التطبيقية بالمستقلة يبقى نعتا فقهيا دون أن يتمتع بأي هوية قانونية[5] فالمقررات التنظيمية المستقلة لا تحتل مرتبة وسط بين القوانين و القرارات التنظيمية التطبيقية بل يبقى لها نفس الدرجة و التصنيف مع هذه الأخيرة و نعتها بالمقررات التنظيمية المستقلة يجد سنده في الفصل 71 من الدستور الذي حدد مجال التنظيم بعد حصر مجال القانون، إذ تستمد هذه المقررات مشروعيتها من نص الدستور مباشرة دون وساطة القانون و دون تبعية له كما هو الشأن بالنسبة للمقررات التنظيمية التطبيقية.
و يجدر التنبيه أن خصوصيات العمومية و التجريد التي ذكرناها سابقا و التي تتمتع بها المقررات التنظيمية ليست قاعدة مطلقة بالنسبة للمراسيم في المغرب إذ أن هذه الأخيرة و التي تصنف كمراسيم مستقلة أي التي تأخذ مشروعيتها مباشرة من نص الدستور قد تأخذ شكل قرارات إدارية فردية تفتقد لخصائص العمومية و التجريد و بالتالي يستنفذ موضوعها بمجرد تطبيقها مرة واحدة كما هو الشأن بالنسبة للمرسوم المنصوص عليه في الفصل 65 من الدستور الذي ينص على أنه " إذا استمرت جلسات البرلمان أربعة أشهر على الأقل في كل دورة، جاز ختم الدورة بمرسوم " و كذلك الأمر بالنسبة للمرسوم المنصوص عليه في الفصل 75 من الدستور الذي جاء فيه " إذا لم يتم في نهاية السنة المالية التصويت على قانون المالية أو لم يصدر الأمر بتنفيذه بسبب إحالته إلى المحكمة الدستورية تطبيقا للفصل 132 من الدستور فإن الحكومة تفتح بمرسوم الاعتمادات اللازمة لسير المرافق العمومية و القيام بالمهام المنوطة بها على أساس ما هو مقترح بالميزانية المعروضة على الموافقة ".
يتضح أن الاستناد على خصائص العمومية و التجريد كمعيار للتمييز بين القرارات الإدارية الفردية و القرارات الإدارية التنظيمية المعروفة بالمراسيم في المغرب لا يسعفنا في التمييز بين هذين النوعين من القرارات إذ يمكن أن تتجرد المراسيم من خصائص العمومية و التجريد و تبقى قرارات ينتهي مفعولها بمجرد نفاذها و تطبيقها على حالة معينة كما هو الشأن بالنسبة للقرارات الفردية، مما يفتح المجال للمشرع الذي يبقى بيده أمر التصنيف من خلال تحديد القرار الإداري إن كان قرارا فرديا أو قرارا تنظيميا يطلق عليه اسم مرسوم.
المطلب الثاني: تمييز القرار التنظيمي عن القانون.
لقد كان تمييز القانون عن اللائحة { المرسوم أو القرار التنظيمي} أمرا يسيرا في ظل الدساتير الأولى للثورة الفرنسية لكون مبدأ الفصل بين السلطات كان فصلا مطلقا بحيث كان يمنع على السلطة التنفيذية منعا كليا التدخل في مجال التشريع، و من ثم كان يسهل تعريف القانون بكونه القاعدة العامة المجردة التي تطبق على كل من تتوافر فيه شروط تطبيقها بحيث لا تخص حالة بعينها أو شخصا بذاته[6]، و أمام تطور تدخلات الإدارة في الحياة العامة فقد تم التخفيف من جمود مبدأ الفصل بين السلطات بحيث أصبح للإدارة إمكانية إصدار مقررات تنظيمية تتضمن قواعد عامة مجردة تقترب في شكلها من القوانين و بالتالي أصبحت الحاجة إلى التمييز بين القانون و اللائحة أكثر إلحاحا من ذي قبل مما حدا بالفقهاء إلى البحث عن معايير خاصة للتمييز بين القانون و التنظيم و قد انتهى هذا البحث إلى إيجاد معيارين مختلفين للتمييز هما المعيار الشكلي و المعيار الموضوعي.
أ- المعيار الشكلي.
يركز أنصار هذا المعيار على صفة القائم بالعمل دون تركيز على مضمون العمل في حد ذاته، و بناءا عليه فقد يتشابه عملين في مضمونهما أو يتطابقان و مع ذلك سيحمل أحدهما الصبغة الإدارية و سيحمل الآخر الصبغة التشريعية فقط لكون السلطة الصادر عنها العمل سلطة إدارية أو تشريعية،[7] و سيكون بالتالي العمل إداريا إذا صدر عن سلطة إدارية و تشريعيا إذا صدر عن سلطة تشريعية.
وبناءا على ما سبق يعرف أنصار هذا المعيار القانون بكونه التصرف الصادر عن البرلمان بناءا على تصويت منه طبقا للقواعد التي يقررها الدستور،دون النظر إلى كونه يتضمن قواعد عامة مجردة أم لا، بينما يعرفون القرار التنظيمي { اللائحة أو المرسوم} بكونه عملا إداريا يصدر عن الإدارة من حيث كونها سلطة إدارية بغض النظر عن مضمونه و محتواه أو مدى تأثيره في المراكز القانونية[8]، حيث يرفض أنصار هذا المعيار اعتبار المقرر التنظيمي تشريعا حتى بالنسبة للمقررات التنظيمية المستقلة التي أشرنا إليها سابقا و التي تستمد مشروعيتها مباشرة من الدستور دون الحاجة إلى وساطة القانون.
و ما يمكن ملاحظته من خلال المعيار الشكلي هو عدم إعطائه أهمية لمضمون العمل في ذاته و اكتفائه بالتركيز على السلطة المصدرة للعمل لتحديد طبيعته و هذا أمر من الصعوبة بما كان نظرا للمرونة التي أصبح يكتسيها مبدأ الفصل بين السلطات بحيث يمكن أن تصدر عن السلطة التشريعية أعمال ذات صبغة إدارية كما هو الشأن بالنسبة للقرارات التي يمكن أن تصدر عن البرلمان فيما يتعلق بشؤون موظفيه، كما أن الأعمال الصادرة عن السلطة القضائية لا تعتبر كلها أعمالا قضائية بالضرورة بل يمكن أن تصدر عن هذه السلطة أعمال إدارية بطبيعتها تخضع لمبدأ المشروعية و رقابة القاضي الإداري شأنها شأن بقية الأعمال الإدارية، لذلك كان من الضروري الاستناد على معيار آخر للتمييز بين العمل التشريعي و العمل الإداري يركز على طبيعة العمل في كنهه بدل الاكتفاء بالتركيز على السلطة المصدرة للعمل.
ب -المعيار الموضوعي.
بعكس المعيار الشكلي فإن المعيار الموضوعي يعطي أهمية كبيرة لموضوع العمل في ذاته، و ذالك دون التركيز على الهيئة أو السلطة التي كان العمل صادرا عنها و ذلك تأكيدا من هذا المعيار على أن طبيعة العمل لا تتغير بتغير الهيئات المصدرة له أو تغير الأشكال و المساطر التي يصدر من خلالها العمل.
و استنادا على هذا فإنه يدخل في زمرة الأعمال التشريعية كل من القوانين و اللوائح ما دامت تتضمن قواعد عامة و مجردة ملزمة، فحسب الفقيه هوريو لم تعد صفة العمومية مقصورة على التشريع بل امتدت أيضا إلى اللوائح كما لم تعد خاصية وضع التفصيلات و الجزئيات مقصورة على اللائحة بل امتدت أيضا إلى القانون و خصوصا القوانين التي تمس حقوق الأفراد و حرياتهم بصفة مباشرة، حيث تضطر هذه القوانين المشرع إلى وضع التفصيلات و الجزئيات الضرورية لتطبيقها[9].
و يعرف هوريو اللائحة بكونها تعبيرا عن إرادة الإدارة في شكل قاعدة عامة تقررها هيئة تتمتع بسلطة إصدار اللوائح، و يرى الفقيه أن السلطة اللائحية أمر لا تستغني عنه أي دولة في الوقت الحاضر و يصفها بأنها مظهر هام لسلطات الدولة.
و بشكل عام فأنصار المعيار الموضوعي قد وسعوا من نطاق الأعمال التشريعية بحيث يعتبر عملا تشريعيا كل عمل يكتسي خصائص العمومية و التجريد و هو ما من شأنه أن ينعكس بدوره على نطاق الرقابة القضائية التي يمكن أن تمارس على المقررات التنظيمية أو اللوائح.
المبحث الثاني : المقررات التنظيمية و مبدأ المشروعية.
يقتضي مبدأ المشروعية أن تخضع كل الأعمال و التصرفات الصادرة عن الإدارة للرقابة القضائية كمبدأ عام و إلى اتسم عمل الإدارة بالشطط في استخدام السلطة إلا ما تم استثنائه من هذه الرقابة بنص خاص كما هو الشأن بالنسبة لأعمال السيادة و أعمال السلطة التشريعية، و المقررات التنظيمية كما سبق الذكر هي أعمال تصدر عن السلطة التنفيذية أي أنها تعتبر أعمالا إدارية بحكم المعيار الشكلي و تخضع بالتالي لمبدأ المشروعية و رقابة القضاء الإداري، لكن هذه المقررات تحمل كذلك خصائص العمومية و التجريد التي تميز النصوص القانونية.
المطلب الأول: مشروعية اللوائح في الأنظمة المقارنة.
في ظل الدساتير الفرنسية القديمة كان مبدأ الفصل بين السلطات مبدءا جامدا بحيث لم تكن تمتلك السلطة التنفيذية أي اختصاص تشريعي إلى على سبيل الاستثناء حيث ظل هذا المجال حكرا على السلطة التشريعية ولم تمتلك السلطة التنفيذية أي مجال محجوز فيما يتعلق بالتشريع، بحيث كان المعيار الشكلي الذي تحدثنا عنه سابقا هو السائد في تمييز العمل بين التشريعي و الإداري و بحكم سيادة هذا المعيار و تصلب مبدأ الفصل بين السلطات فقد اعتبرت المقررات التنظيمية سواء التطبيقية أو المستقلة أعمالا إدارية تخضع لمبدأ المشروعية و تمتد إليها رقابة القاضي الإداري،[10] و بعد صدور دستور 1958 فقد تم تحديد مجال القانون و توسيع مجال التنظيم بحيث تبقى المجالات التي لم يحددها المشرع كاختصاص للقانون كلها من اختصاص التنظيم.
و نظرا لاتساع مجال التنظيم مقارنة بمجال القانون و حساسية المجالات التي يمكن أن تشرع فيها السلطة التنفيذية بناءا على ذلك كالمجالات التي تمس حقوق و حريات الأفراد و نظرا لما تشمله اللوائح المستقلة من خصائص العمومية و التجريد التي تجعلها منافسة للنصوص القانونية مما يفتح المجال للانفلات من الرقابة القضائية و نظرا لغياب رقابة قضائية على المقررات التنظيمية فقد حاول الفقه الفرنسي جاهدا الدفاع عن مبدأ المشروعية حيث اعتبر بعض الفقهاء مثل "Montane De la Roque" أن اللوائح التنظيمية "هي بالأساس أعمال إدارية لا تعدو كونها قرارات إدارية، و بالرغم من تحديد نطاق تشريعي محدد لها بنص الدستور فإن ذلك لا ينفي عنها الصبغة الإدارية و تبقى خاضعة لرقابة القضاء فيما يخص مشروعيتها و ذلك بدعوى تجاوز السلطة أي دعوى الإلغاء"[11].
وقد ذهب جانب من الفقه إلى أن تقلص مجال القانون مقارنة بمجال التنظيم و كذا تمتع اللوائح التنظيمية المستقلة بخصائص العمومية و التجريد لا يعني أنها حلت محل القانون و أخذت مكانه، فلكل من القانون و اللائحة المستقلة مكانه الخاص، كما أن توزيع الاختصاص التشريعي بين القانون و اللائحة لا يعني مطلقا أن اللوائح التنظيمية متساوية مع القوانين، فاللوائح التنظيمية لازالت تعتبر قرارات إدارية وفقا للمعيار الشكلي، و من ثم فإنها تخضع لرقابة القضاء الإداري على مشروعيتها .
لكن هذا الرأي قد وجد من يخالفه في أوساط الفقه الفرنسي، حيث ذهب اتجاه فقهي آخر إلى القول بكون اللوائح المستقلة لا يمكن أن تتضمن عيبا من عيوب المشروعية (أي مخالفة القانون بمعناه الضيق) لكونها تتضمن في ذاتها القواعد القانونية مما يشكل استحالة للطعن فيها لمخالفة القانون.
و يرد الفقيه والين على هذا الطرح بكون الفقه بغالبيته قد اتفق على وجوب انضباط اللوائح التنظيمية المستقلة للمبادئ القانونية العامة و هي القواعد القانونية الغير المكتوبة التي يكتشفها أو يستنبطها القضاء و يعلنها في أحكامه بحيث تكتسب قوة إلزامية، فإذا أمكن انفلات اللوائح التنظيمية من قيود القواعد القانونية بمعناها الضيق كأحد مصادر مبدأ المشروعية فإنها لا يمكن أن تفلت من المبادئ القانونية العامة كأحد المصادر الأساسية لمبدأ المشروعية[12]، و بالتالي ستبقى اللوائح التنظيمية المستقلة خاضعة لمبدأ المشروعية و مصنفة كأعمال إدارية طبقا للمعيار الشكلي و إن منحها الدستور نطاقا محجوزا للتشريع.
و قد قرر مجلس الدولة الفرنسي الالتزام بما وصل إليه الاجتهاد الفقهي بحيث اعتبر اللوائح التنظيمية المستقلة أعمالا إدارية تصدر على شكل قرارات إدارية عامة، و قيدها بضرورة عدم مخالفة المبادئ العامة للقانون، حيث أعلن في قراره في قضية "Syndicat" الصادر سنة 1958 بأن " اللوائح المستقلة و إن لم تخضع للقانون، فإنها تخضع كأي لائحة أخرى لما تقرره المبادئ القانونية العامة[13] ".
كما أعلن في قرار ""ERY الصادر سنة 1960 " بما أن اللوائح المستقلة كغيرها من اللوائح تصدر عن السلطة الإدارية فهي تخضع لرقابة القضاء الإداري من ناحية مشروعيتها[14] ".
و قد تتابعت قرارات مجلس الدولة في هذا الشأن مؤكدة الطبيعة الإدارية للوائح المستقلة معتمدا المعيار الشكلي في التمييز بين القانون و اللائحة مع ضرورة خضوعها للمبادئ القانونية العامة.
المطلب الثاني: مشروعية اللوائح {المراسيم} في النظام القانوني المغربي.
للحديث عن إمكانية مراقبة شرعية المراسيم من قبل القضاء الإداري المغربي يجب الانطلاق من نصين أساسيين هما الفقرة الثانية من الفصل 118 من الدستور التي جاء فيها " كل قرار اتخذ في المجال الإداري، سواء كان تنظيميا أو فرديا، يمكن الطعن فيه أمام الهيئة القضائية الإدارية المختصة" و كذلك المادة 09 من القانون 41-90 المحدث بموجبه محاكم إدارية التي جاء فيها " يظل المجلس الأعلى مختصا بالبث ابتدائيا و انتهائيا في طلبات الإلغاء بسبب تجاوز السلطة بالنسبة ل:
- المقررات التنظيمية و الفردية الصادرة عن الوزير الأول.
- قرارات السلطات الإدارية التي يتعدى نطاق تنفيذها دائرة الاختصاص المحلي لمحكمة إدارية.
و انطلاقا من هذا فإن فتح المجال أمام القضاء الإداري لمراقبة مشروعية المراسيم بطريق دعوى الإلغاء من شأنه أن يلغي هذه المقررات التنظيمية التي تتضمن قواعد عامة و مجردة بالنسبة للجميع، حيث يكفي توفر شرط الصفة و المصلحة في مدعي واحد مس القرار التنظيمي بمركزه القانوني ليكون له الحق بالطعن في القرار عن طريق دعوى الإلغاء و بالتالي إعدام القرار بالنسبة لكافة المعنيين به إذا ثبت أنه مشوب بعيب من عيوب عدم المشروعية، أي إلغاء المرسوم إلغاءا كليا مادام المرسوم يهم جميع الأفراد اللذين تنطبق عليهم شروط معينة.
و يمكن أن تستثنى من رقابة مبدأ المشروعية بعض المراسيم الخاصة من قبيل مراسيم الضرورة و المراسيم التفويضية و هي ما تعرف بمراسيم القوانين و هي المنصوص عليها في الفصل 70 و 81 من الدستور و هي مقررات تنظيمية تتخذ من طرف الحكومة تحت رعاية البرلمان فهي من حيث القوة القانونية تكون مجرد قرارات تنظيمية تخضع لمبدأ المشروعية لكن بمجرد مصادقة البرلمان على هذه المقررات بصفة نهائية فإنها تنتقل إلى مرتبة القوانين العادية [15] و تتحصن بذلك من رقابة القاضي الإداري كمبدأ عام شأنها شأن القوانين.
و رغم كون الفصل 118 من الدستور قد عمل على تكريس رقابة القضاء الإداري لأول مرة للمقررات التنظيمية من داخل أسمى النصوص القانونية فإن المادة 09 من قانون 41-90 قد أسست سابقا لها النوع من الرقابة من خلال التنصيص على اختصاص المجلس الأعلى بالبث ابتدائيا و انتهائيا في طلبات الإلغاء بسبب تجاوز السلطة بالنسبة للمقررات التنظيمية و الفردية الصادرة عن الوزير الأول أي خضوع هذه المقررات لمبدأ المشروعية من خلال رقابة أعلى هيئة قضائية إدارية و هي المجلس الأعلى محكمة النقض حاليا، و الملاحظ أن المشرع من خلال المادة 09 قد ساوى بين المقررات التنظيمية و الفردية الصادرة عن الوزير الأول من حيث خضوعها لرقابة أعلى هيئة قضائية إدارية، حيث لم يجعل المشرع المعيار في خضوع هذه المقررات لهذا النوع من الرقابة هو كون هذه المقررات تنظيمية أو فردية بل المعيار في انعقاد الاختصاص للمجلس الأعلى محكمة النقض حاليا لرقابة هذا النوع من المقررات يرتكز على الجهة المصدرة للقرار، و هذا ينسجم مع ما ذكرناه سابقا من كون المراسيم بالمغرب لا يعني بالضرورة أن تتميز بخصائص العمومية و التجريد، حيث يمكن أن يستنفذ المرسوم مفعوله لمجرد تطبيقه شأنه شأن القرارات الإدارية الفردية، و تكريس هذه الرقابة من داخل الوثيقة الدستورية قد جاء انسجاما مع بقية المقتضيات القانونية التي زخر بها دستور 2011 لاسيما الفصل 122 الذي نص لأول مرة على مسؤولية الدولة عن الخطأ القضائي موسعا بذلك نطاق دعوى المسؤولية الإدارية لتشمل الأعمال القضائية التي كانت تشكل استثناءا من رقابة القضاء الإداري كمبدأ عام فكان منطقيا توسيع مجال دعوى الإلغاء لتشمل المقررات التنظيمية من خلال الفصل 118 من الدستور.
و قد أثارت مسألة كيفية خضوع المقررات التنظيمية لمبدأ المشروعية عدة تساؤلات من قبل الفقه و الاجتهاد القضائي الفرنسي سابقا نظرا لصعوبة تطبيق رقابة مبدأ المشروعية من خلال العيوب التي يمكن أن يثيرها هذا المبدأ بالنسبة للقرار الإداري و التي يصعب تطبيقها على قرار يختزن في مضمونه قواعد عامة و مجردة كالقرار التنظيمي لذلك فإن القاضي الإداري قد يتجه لمراقبة مدى احترام المقررات التنظيمية التطبيقية لمضمون النص القانوني المكلفة بتنزيله و تنفيذه كما يمكنه مراقبة مدى احترام المقررات التنظيمية المستقلة للقواعد العامة للقانون و هي مصدر مهم من مصادر مبدأ المشروعية، و هو الأمر الذي ينسجم مع تطور رقابة القضاء الإداري التي أصبحت تمتد أكثر فأكثر تحصينا و حماية لحقوق الأفراد، حيث أصبح القاضي يمارس رقابته من خلال دعوى المسؤولية الإدارية على الأعمال القضائية و الأعمال التشريعية و هو ما يجعل خضوع المقررات التنظيمية لمبدأ المشروعية ينسجم مع هذا التطور تكريسا لعمومية مبدأ المشروعية الذي يجب أن تخضع له كافة الأعمال الصادرة عن الدولة إلى ما استثني بموجب نصوص خاصة تكريسا لدولة الحق و القانون و احتراما لمفهوم المواطنة الذي يرتكز على خضوع المواطن و الدولة على السواء لحكم القانون.
via MarocDroit - موقع العلوم القانونية http://ift.tt/2bTMkDI


